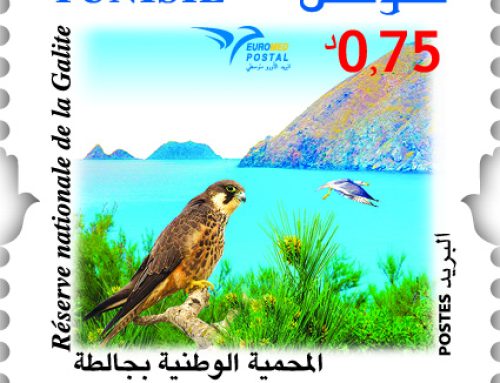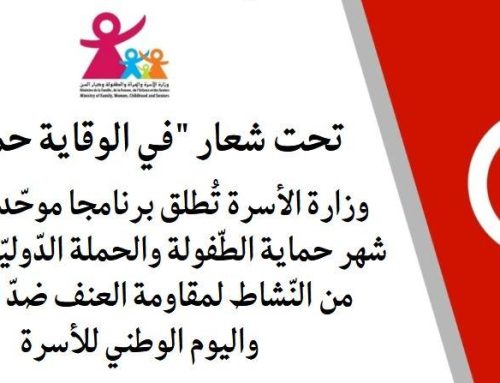ناجح الزغدودي-صحفي وباحث في علم الاجتماعي
نشر المرصد التونسي للمناخ بتاريخ 23 أوت 2025 أن نسبة امتلاء السدود في تونس 31.1% بمخزون 736مليون م³، مقارنة بالسنة الماضية 557 مليون م³، سدود الشمال 36.5% اليوم. ولئن شهدت تعبئة السدود تحسنا مقارنة بالعام الفارط مما يعني مخزونا مائيا أفضل، فان هذا التطور يبقى رهين عدة عوامل مناخية وسلوك استهلاكي وتخطيط متلائم مع التغيرات المناخية المتوقعة.
حيث تفيد عدة دراسات وتوقعات ان تشهد البلاد التونسية تأثرا شديدا بظاهرة التغير المناخي مما يستوجب وضع استراتيجات تأقلم وتشريعات تساعد المواطنين على المواجهة وتمكين الفئات الاجتماعية من الصمود امام متغيرات الحرارة والجفاف والفيضانات المتوقعة وتأثيراتها المحتملة.
يشمل هذا التقرير تحليلاً شاملاً لتأثيرات تغير المناخ في تونس، بناءً على بيانات وتوقعات من مصادر متعددة، بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ومجموعة البنك الدولي. يتناول التقرير التغيرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار، وتأثيرها على قطاعات حيوية مثل المياه، والزراعة، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى المخاطر الطبيعية التي تهدد البلاد.
الجغرافيا والسكان والمناخ
تونس، الدولة الواقعة في أقصى شمال أفريقيا، تتميز بتنوع جغرافي لافت، من السهول الساحلية الخصبة في الشمال إلى الصحاري القاحلة في الجنوب. يبلغ عدد سكانها أكثر من 12 مليون نسمة، يتركز معظمهم في المناطق الحضرية وعلى طول ساحلها المتوسطي البالغ طوله 1,148 كيلومتراً. يساهم هذا التنوع الجغرافي في وجود مناطق مناخية مختلفة، من مناخ البحر الأبيض المتوسط في الشمال إلى المناخ الصحراوي في الجنوب.
هذه الأرض المتوسطية التي لطالما تغنّت بخصوبتها وتنوعها الجغرافي، تواجه اليوم تحديات مناخية غير مسبوقة تهدد استقرارها البيئي والاقتصادي. فمنطقة شمال أفريقيا، بما فيها تونس، تُعدّ “نقطة ساخنة” لتغير المناخ، حيث ترتفع درجات الحرارة فيها بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي، مما ينذر بمستقبل أكثر جفافاً وحرارة وفق ما جاء في دراسة للبنك الدولي (شريك تنموي لتونس) في شهر أوت.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن تونس شهدت ارتفاعاً في درجات الحرارة بمعدل ينذر بالخطر، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع ليصل إلى 0.38 درجة مئوية لكل عقد حتى عام 2050. هذا الواقع ليس مجرد أرقام وبيانات، بل له انعكاسات مباشرة على حياة التونسيين. فعدد الأيام الحارة وفق البيانات (أكثر من 35 درجة مئوية) سيزداد من شهرين إلى ثلاثة أشهر سنوياً، مما يرفع من مخاطر الأمراض المرتبطة بالحرارة ويزيد الضغط على شبكات الكهرباء.

تتناول الدراسة بيان نسبة السكان المعرضين لمخاطر صحية عالية بسبب درجات الحرارة شديدة الارتفاع، حيث تُعرّف المناطق عالية الخطورة بأنها تلك التي يتجاوز فيها عدد الأيام السنوية التي تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى 40 درجة مئوية العشرين يومًا.
على المستوى الوطني: من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المعرضين لدرجات حرارة خطيرة بشكل كبير. فبينما كانت النسبة 10% خلال الفترة من 1975 إلى 2025، يُتوقع أن تصل إلى 67% في الفترة من 2050 إلى 2099.
التغيرات في درجات الحرارة
شهدت تونس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بمعدل 0.46 درجة مئوية لكل عقد بين عامي 1971 و 2020، وهو ما يفوق المتوسط العالمي. من المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع بمعدل 0.38 درجة مئوية لكل عقد حتى عام 2050. سيؤدي هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في عدد الأيام الحارة (التي تتجاوز 35 درجة مئوية)، حيث سترتفع من 57 يومًا سنويًا إلى 84 يومًا بحلول منتصف القرن. كما ستزداد الليالي الاستوائية (التي تتجاوز 23 درجة مئوية) من 55 ليلة سنويًا إلى 89 ليلة. ستصبح الأيام الحارة والرطبة أكثر تواترًا، مما يرفع من مؤشر الحرارة الخطير، الذي من المتوقع أن يؤثر على معظم السكان بحلول نهاية القرن.
التغيرات في هطول الأمطار والجفاف
من المتوقع أن ينخفض متوسط هطول الأمطار السنوي بنسبة 7.9% بحلول عام 2059، مع انخفاض أكبر في المناطق الشمالية الغربية. على الرغم من أن هذا التراجع قد يبدو طفيفًا، إلا أنه سيزيد من حدة الجفاف. يُتوقع أن يزداد عدد الأيام الجافة المتتالية، مما يفاقم من ندرة المياه ويؤثر على الزراعة. في المقابل، من المتوقع أن تصبح ظواهر هطول الأمطار المتطرفة أكثر تواترًا، مما يزيد من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية.
توزيع المخاطر حسب المناطق
تُظهر المناطق المختلفة في تونس مستويات متفاوتة من التعرض لهذه المخاطر:
المناطق الجنوبية القاحلة:
يعاني جزء كبير من سكان هذه المناطق بالفعل من التعرض لدرجات حرارة شديدة الخطورة، حيث بلغت النسبة في الفترة من 1975 إلى 2025 87% في تطاوين، و92% في توزر، و100% في قبلي.
يُتوقع أن يزداد هذا التعرض بشكل كبير بحلول منتصف القرن، ليصل إلى أكثر من 98% في قفصة، وتوزر، وتطاوين، ونحو 100% بحلول عام 2075 في قابس.
المناطق الداخلية الشمالية:
ستبدأ هذه المناطق في مواجهة هذه الظروف القاسية بحلول منتصف القرن. وبحلول عام 2050، سيصل التعرض إلى ما يقارب 100% في سيدي بوزيد، بينما سيبلغ 65% في القيروان.
ستكون معدلات التعرض في الكاف، والقصرين، وصفاقس 32% و39% و39% على التوالي، ومن المحتمل أن يتعرض جميع سكانها لهذه المخاطر بحلول عام 2075.
بحلول عام 2075، ستواجه المناطق الشمالية مثل جندوبة، وباجة، ومنوبة مستويات تعرض كبيرة، حيث سيُصاب 55% و76% و94% من سكانها على التوالي.
المناطق الساحلية الشمالية:
ستشهد هذه المناطق، بما فيها بنزرت، وأريانة، وتونس، وبن عروس، تعرُضاً سكانياً لهذه المخاطر بحلول عام 2075، ولكن بدرجة أقل، حيث يوفر موقعها الساحلي بعض الحماية من الحرارة الشديدة.
تواجه المناطق الساحلية، التي تتركز فيها الأنشطة السكانية والاقتصادية، تهديدات متزايدة. حيث ارتفع منسوب سطح البحر بمقدار 9 سم منذ عام 1993، ومن المتوقع أن يرتفع بمقدار 23 سم إضافية بحلول عام 2050، و68 سم بحلول عام 2100. هذا الارتفاع، بالإضافة إلى ارتفاع درجات حرارة سطح البحر والعواصف، سيزيد من مخاطر الفيضانات الساحلية وتآكل الشواطئ، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والبنية التحتية الحيوية.

الظواهر المتطرفة في هطول الأمطار
في عالم أكثر حرارة، تزداد قدرة الهواء على حمل الرطوبة بشكل كبير، وبالتالي يزداد احتمال هطول أمطار أكثر غزارة. وكما هو متوقع، فإن فترة تكرار هطول الأمطار الأشد غزارة في يوم واحد تتناقص في تونس في جميع أنحائها تقريباً. وهذا يعني أن ظواهر هطول الأمطار الغزيرة ستتكرر على الأرجح بشكل أكبر (أي أن فترة التكرار ستتناقص)، مما قد يؤثر سلبًا على مخاطر الفيضانات ويشكل خطراً على البنية التحتية، وسلامة الإنسان، والزراعة.
وبالتالي ستصبح الفيضانات المفاجئة أكثر تواتراً بسبب غزارة الأمطار المصحوبة بظروف الجفاف العامة.
علاوة على بوادر الظواهر النادرة والتي يُتوقع أن يكون أكبر تغيير في الظواهر النادرة التي تحدث كل 100 عام، حيث ستصبح أكثر تواتراً بنسبة 20% بحلول عام 2050، وستتضاعف وتيرتها بحلول نهاية القرن.
وسط هذه المؤشرات ينشأ مفهوم “عدم اليقين” على الرغم من هذه التوقعات، فإن درجة عدم اليقين في التنبؤات كبيرة، خاصة بالنسبة للظواهر النادرة جدًا التي تحدث كل 100 عام.
وستكون المناطق الساحلية الشمالية الشرقية مثل بن عروس وأريانة هي الأكثر تأثراً بهذه التغيرات الكبيرة.
آثار الحرائق وتداعياتها
من جهة ثانية ترتبط الحرارة المفرطة والجفاف ارتباطاً وثيقاً بزيادة خطر حرائق الغابات التي تشكل تهديداً للمناطق الطبيعية والأراضي الزراعية. فمع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأيام الحارة، ستصبح الغابات والمناطق الحرجية أكثر عرضة للاشتعال، مما يؤدي إلى خسائر بيئية واقتصادية فادحة يصعب تعويضها.
تأثيرات على الأمن الغذائي وسبل العيش
ان تغير المناخ يهدد الأمن الغذائي في تونس من خلال عدة عوامل:
منها التصحر الذي يتسارع بفعل الأنشطة البشرية وتغير المناخ، مما يقلل من الأراضي الصالحة للزراعة ويهدد الأمن الغذائي.
وأيضا تاثير على الزراعة والثروة الحيوانية حيث من المتوقع أن يؤدي الجفاف وارتفاع درجات الحرارة إلى خسائر كبيرة في المحاصيل مثل الزيتون والحبوب، كما ستعاني الثروة الحيوانية (مثل الأغنام) من إجهاد حراري متزايد.
كما تؤثر على الثروة البحرية ومن المتوقع أن تنخفض الكتلة الحيوية للحيوانات البحرية بنسبة تصل إلى 40% على طول الساحل التونسي بحلول نهاية القرن.
المخاطر الطبيعية وجهود التكيف
تُعد الفيضانات (فيضانات الأنهار، الفيضانات الحضرية، والساحلية)، والحرارة الشديدة، وحرائق الغابات هي أعلى المخاطر الطبيعية التي تواجه تونس. لمواجهة هذه التحديات، قدمت تونس مساهماتها المحددة وطنياً (NDC) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة على جهودها في تعزيز الاستدامة البيئية، وحماية الموارد المائية، وتطوير القطاعات الحيوية، وزيادة قدرتها على التكيف مع تغير المناخ.
في هذا السياق، تبرز ولاية القيروان كنموذج صارخ لتفاقم الأزمة. فبصفتها من المناطق الداخلية التي تسجل أرقاماً قياسية في الحرارة، يُتوقع أن تشهد زيادة في الأيام الحارة بمعدل يتجاوز 7 أيام إضافية لكل عقد، وهو ما يضع سكانها تحت وطأة موجات حر غير مسبوقة.
أما الجفاف، فهو الوجه الآخر لهذه الأزمة. فمع الانخفاض المتوقع في معدل هطول الأمطار بنسبة 7.9%، ستزداد فترات الجفاف الممتد، مما يؤثر بشكل مباشر على الموارد المائية.
تأثير على الموارد المائية والزراعة
إن تراجع منسوب المياه في السدود، مثل سد نبهانة وسيدي سعد في القيروان، والذي وصل الى حد غلق السد بعد تسجيله ادنى مخزون له في اوت 2023 ليس مجرد حدث عابر، بل هو مؤشر على أزمة مياه حقيقية. وكانت لها تداعيات اقتصادية وتنموية واجتماعية ليس اقلها تراجع الإنتاج وتقلص المساحات الزراعية واضرار ايكولوجية فضلا عن مشاكل بيئية وصحية وتدهور الأنشطة اليومية.
ففي ظل زيادة الطلب على مياه الري وتراجع منسوب المياه الجوفية، ستصبح الزراعة في خطر. وكون القيروان منطقة فلاحية بامتياز، فإن هذا التراجع يهدد الأمن الغذائي الوطني، خاصة وأن الإنتاج الزراعي في القطاعات الرئيسية مثل الزيتون والحبوب والثروة الحيوانية سيتأثر بشدة.
ويُتوقع، وفق الدراسة أن يؤدي هذا النقص في المياه إلى خسائر كبيرة في المحاصيل، مما يضر بالمزارعين ويهدد سبل عيشهم، خاصة الفئات الهشة التي تعتمد بشكل كلي على الزراعة. كما تواصلت مظاهر العطش والانقطاع المتكرر لشبكات مياه الشرب سواء لشبكة توزيع المياه التابعة للصوناد او للمجامع المائية.
وقد ينتج عن هذه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تداعيات مستقبلية اكبر مما يستدعي وضع استراتيجيات وبدائل للتعامل مع الظاهرة ودعم قدرات السكان على المواجهة والصمود عبر جملة من البرامج البيئية والتنموية والاجتماعية بالشراكة مع الاعلام والمجتمع المدني ونشر الوعي ضمن سياسة بيئية تحقق العدالة المناخية للجميع.
إن الواقع المناخي في تونس ليس مجرد توقعات علمية، بل هو واقع معيشي يفرض نفسه بقوة. ويتطلب من الحكومة والمجتمع المدني والفئات المتضررة تضافر الجهود لتبني استراتيجيات تكيف فعالة، من خلال إدارة مستدامة للموارد المائية، وتطوير أساليب زراعة مقاومة للجفاف، وتوعية المواطنين بمخاطر تغير المناخ، وصيانة الشبكات المائية وهيكلة المجامع المائية والتصدي للهدر المائي وتبخر السدود وذلك لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.